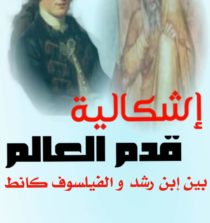تتناول هذه الدراسة بالمقارنة موقف كل من ابن رشد (1126-1198) وكانط (1724-1804) من إشكالية قدم العالم وحدوثه. لقد كانت هذه الإشكالية محورية في الفكر الإسلامي، ومحل نزاع بين المتكلمين والفلاسفة. أثبت الفارابي وابن سينا قدم العالم بالضد على المتكلمين، معتزلة وأشاعرة وغيرهم، وكفرهما الغزالي في كتابه الشهير “تهافت الفلاسفة”؛ وعاد ابن رشد للدفاع عن الفلسفة وتبنى نظرية قدم العالم وقدم لها براهين جديدة خالف بها الفارابي وابن سينا، وأعاد صياغة النظرة الأرسطية للعالم بوجهة نظر إسلامية، وذهب إلى أن إثبات وجود الله لا يتأتي من دليل الحدوث الكلامي الجدلي بل من دليل القدم البرهاني الفلسفي.
وعلى الجانب الآخر نجد أن إشكالية القدم والحدوث كانت لا تزال تشغل الفكر الأوروبي الحديث، وخاصة كانط في كتابه “نقد العقل الخالص”. أراد كانط من كتابه تقديم نقد للميتافيزيقا التقليدية، عن طريق توضيح أنها علم غير مشروع، بسبب أنها تمثل توسيعاً لتصورات ملكة الفهم البشري إلى ما يتجاوز كل خبرة تجريبية. وإشكالية القدم والحدوث بالنسبة لكانط هي نقيضة Antinomy يقع فيها العقل الخالص؛ إذ أن أدلة القدم وأدلة الحدوث متساوية في القيمة. ولا يستطيع العقل الخالص الفصل في هذه الإشكالية ويظل متناقضاً مع نفسه إزاءها. وانتهى كانط إلى عدم قدرة العقل البشري على ترجيح أحد المتناقضين.
يشترك ابن رشد وكانط إذن في البحث في إشكالية واحدة. دافع ابن رشد عن القدم ، أما كانط فرفض الفصل في الإشكالية وقام بالتوقف عن الحكم ورفع النقيضين معاً. والهدف من هذه الدراسة توضيح أن خيار القدم لدى ابن رشد أكثر اتساقاً ومعقولية من رفض كانط للإشكالية برمتها، وذلك بإثبات أن كانط لم يكن محقاً في تخليه عن الفصل في الإشكالية، وأنه وضعها في صورة مبسطة للغاية سهلت عليه التخلي عنها، في حين أن تناول ابن رشد للإشكالية كان أكثر شمولاً وتنوعاً واتساقاً، وحله كان أكثر معقولية.
أولاً – الخلفية الأرسطية للمشروع النقدي الرشدي والكانطي:
نحاول في هذه الدراسة عقد مقارنة بين المشروعين النقديين لابن رشد ولكانط، مركزين على إشكالية مركزية وهامة عالجها كل منهما بطريقته الخاصة وحسب مذهبه الفلسفي، وهي إشكالية قدم العالم وحدوثه. اشتهر كانط بنقده للميتافيزيقا في عمله الأساسي “نقد العقل الخالص”. وضع كانط هذا النقد تحت عنوان “الجدل الترانسندنتالي” Transcendental Dialectic،( ) وقصد به التناقضات التي يقع فيها العقل الخالص في مجال الميتافيزيقا من جراء توسيع تصورات ملكة الفهم خارج مجال الخبرة التجريبية، سعياً إلى اللامشروط. ينقد كانط كل الميتافيزيقات التقليدية على اعتبار أنها دوجماطيقية، أي تقوم بتوكيدات أنطولوجية بطريقة غير مبررة إبستيمولوجياً. والميتافيزيقا الوحيدة التي يقبلها كانط هي ميتافيزيقا الأخلاق،( ) لأنه لا خوف منها إذ أن توكيداتها الميتافيزيقية تكون في صالح العقل العملي الأخلاقي.
وكذلك كان ابن رشد صاحب مشروع نقدي تمثل في مؤلفاته الثلاثة الهامة: “فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال”، و”الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة”، و”تهافت التهافت”. فقد نقد علم الكلام باعتباره طريقة في التفكير والمحاجة، وبالأخص علم الكلام الأشعري وعلى رأسه الغزالي أهم ممثل له( )؛ لكنه أيضاً لا يرفض كل الميتافيزيقا، إنه يرفض الميتافيزيقا الكلامية فقط، وبالأخص الأشعرية منها، تلك الميتافيزيقا التي تثبت وجود الله وخلود النفس وحدوث العالم من منطلق مقدمات كلامية وباستخدام حجج وأدلة جدلية وخطابية وسوفسطائية، ويدافع عن تصور آخر للكون يعد تطويراً للتصور الأرسطي( ). ويشترك ابن رشد وكانط في البحث في المسائل الثلاث الرئيسية للميتافيزيقا: الله والعالم والنفس. فما هي النتائج التي يمكن أن نتوصل إليها عندما نضع المشروعين النقديين الرشدي والكانطي أمام بعضهما البعض على ما فيهما من اشتراك في المسائل؟ هذا ما سوف نحاول اكتشافه فيما يلي.
أول ما نلاحظه من اتفاق بينهما هو أنهما يعتمدان على خلفية أرسطية وهي المتمثلة في منظومة أرسطو المنطقية، حيث يستفيدان منها في النقد الميتافيزيقي. وثاني أوجه الاتفاق يتمثل في طريقة النقد نفسها والتي تمثلت في نقد ابن رشد لقياس الغائب على الشاهد، وفي نقد شبيه به للغاية لدى كانط وإن لم يستخدم تعبير “نقد قياس الغائب على الشاهد”، بل استخدم تعبيرات أخرى ومارس النقد بطريقة مطابقة لهذا النوع من النقد الرشدي، وهو المعروف بنقد الانتقال من المشروط إلى اللامشروط، أو من سلسلة شروط معطاة إلى لامشروط غير معطى. لنبدأ أولاً بتناول الخلفية الأرسطية، ثم سيأتي الحديث عن نقد قياس الغائب على الشاهد تباعاً.
نقصد بالخلفية الأرسطية منطق أرسطو لا فلسفة أرسطو الطبيعية والميتافيزيقية، فالإثنان استفادا من المنطق الأرسطي كأداة للنقد. أسس كانط نظريته في المعرفة ونقده للميتافيزيقا بالتوازي مع، وعلى أساس نموذج، المنطق الأرسطي، الذي أطلق عليه “المنطق العام”. فمثلما ينقسم المنطق الأرسطي إلى تصورات وأحكام واستدلالات، انقسم المنطق الترانسندنتالي الكانطي Transcendental Logic إلى نفس هذه الأقسام( ). التصورات هي المقولات القبلية، والأحكام هي مبادئ التركيب القبلية بين الحدوس والتصورات، بما أن الحكم يتكون من موضوع ومحمول، فالموضوع في المنطق الكانطي هو الحدس الحسي والمحمول هو التصور القبلي؛ أما مبحث الاستدلالات عند كانط فيظهر في نقده للاستدلالات الميتافيزيقية- الترانسندنتالية للعقل الخالص، وهي الاستدلالات المغالطة Paralogisms لعلم النفس العقلي، والاستدلالات المتناقضة Antinomies للكوزمولوجيا العقلية، والاستدلالات الزائفة لللاهوت العقلي. وكما يحتوي المنطق الأرسطي على الجدل، يحتوي المنطق الكانطي على “الجدل الترانسندنتالي” وهو الذي ينقد فيه علوم الميتافيزيقا الثلاثة.
واعتمد ابن رشد كذلك على المنطق الأرسطي في نقده لعلم الكلام، إذ تبنى المنظومة المنطقية الأرسطية وتمييزها في الأقوال الإقناعية بين البرهان والجدل والخطابة والسفسطة( ). البرهان عند ابن رشد هو خطاب الفلسفة ويعتمد على مبادئ العقول وأوليات الوجود ويوصل إلى اليقين. أما الجدل فهو استدلال يبدو أنه برهاني إلا أنه يعتمد على المشهور لا على اليقيني، والخطابة تقنع باستثارة العاطفة الأخلاقية عند المتلقي، أما السفسطة فهي لا تهدف الإقناع ولا الوصول إلى الحقيقة بل إلى بلبلة الخصم وبث الفوضى والشك في حججه. والخطاب الكلامي في نقد ابن رشد له ليس خطاباً برهانياً لأنه يعتمد على المشهور وعلى مغالطة الاشتراك في الاسم مما يجعله جدلياً، وفي بعض الأحيان يصير خطابياً بل وسوفسطائياً، كما أثبت ابن رشد في نقده للغزالي في “تهافت التهافت” رداً على “تهافت الفلاسفة”.
وظَّف كل من ابن رشد وكانط المنطق الأرسطي في النقد الميتافيزيقي؛ وظَّفه ابن رشد في حل النزاع بين المتكلمين والفلاسفة، أو بين الخطاب الكلامي الجدلي والخطاب الفلسفي البرهاني؛ واستخدمه كانط في حل نزاع العقل الخالص مع نفسه والذي يظهر في صورة أغاليط ونقائض وأوهام يقع فيها في سعيه الميتافيزيقي. والاثنان يواجهان التناقض بين قدم العالم وحدوثه، فهو تناقض زائف عندهما ويمكن حله. لكن في حين يحل كانط التناقض بالتخلي عن الفصل فيها منكراً قدرة العقل على اختيار أو ترجيح أحد طرفي التناقض، يحل ابن رشد التناقض بأن يتوسط بين النقيضين ويقدم حله الشهير وهو نظريته في أن العالم قديم ومحدث في الوقت نفسه.
فما يشترك فيه ابن رشد وكانط حتى الآن هو:
1.البحث في إشكالية واحدة هي القدم والحدوث.
2.نقد الميتافيزيقا، الكلامية في حالة ابن رشد، والدوجماطيقية في حالة كانط، بتوظيف المنطق الأرسطي.
3.توضيح أن التناقض بين القدم والحدوث هو تناقض زائف وأنه يجب التخلي عن البديلين معاً. والفرق هو في الحل الذي قدمه ابن رشد بعد التخلي عن البديلين، في حين أن كانط لم يحسم الأمر.
وعلى الرغم من أن الاثنين يوظفان المنظومة الأرسطية في نقدهما للنزاعات الميتافيزيقية، فإن هناك اختلافاً جوهريا بينهما في هذا الشأن. ففي حين استخدم ابن رشد المنظومة المنطقية الأرسطية كما هي دون تعديل كبير عليها( )، أجرى كانط تعديلات جوهرية على مبحث الجدل الأرسطي بناء على نظريته في المعرفة، وحوله من مجرد معيار لاكتشاف الخطأ في الاستدلال الصوري إلى معيار للحكم على مضمون التفكير الميتافيزيقي نفسه( ). لكن الشئ المشترك بين منطق النقد الكانطي ومنطق النقد الرشدي أن الاثنين يعتمدان على المحسوسات وأوائل العقول كمعيار يقيسان به تعارض المذاهب الميتافيزيقية. فلدى كل واحد منهما لجوء إلى الحس والعقل معاً، أو الحدس الحسي والتصور العقلي بالتعبير الكانطي. الحس والتصور العقلي عند ابن رشد أرسطيان تماماً، لكنهما عند كانط يستندان على نظريته هو في المعرفة والتي يكون التصور العقلي فيها قبلياً.
لم ينشئ ابن رشد نظرية في المعرفة مستقلة عن أرسطو، بل أخذ نظرية المعرفة الأرسطية كما هي لكنه طور استخدامها ووظفها في نقد علم الكلام، والأشعري منه على وجه الخصوص. أما نظرية المعرفة عند كانط فلا نستطيع أن نقول عنها إنها أرسطية تماماً، إلا أن بها ملامح أرسطية لا يمكن إنكارها( ). فالمعرفة عند كانط هي اتحاد من مادة وصورة، المادة توفرها الحدوس الحسية والصورة هي التصورات العقلية القبلية، والتلاحم بينهما هو مثل التلاحم الأرسطي من المادة والصورة، أي أنه لا يمكن فصله، فقد أصر كانط دائماً على أن الحدوس الحسية بدون تصورات عمياء، والتصورات بدون حدوس حسية فارغة. كما يعالج كانط المعرفة من منطلق الملكات والقدرات العقلية، والملكة والقدرة من المصطلحات الأرسطية الشهيرة في وصف أفعال النفس في الإدراك والتصور( ). بل إن تقسيم كانط للملكات المعرفية إلى ملكة الحس Sinnlichkeit/Sensibility وملكة الفهم Verstand/Understanding وملكة العقل Vernunft/Reason يناظر التقسيم الأرسطي لقوى النفس المعرفية إلى العقل الهيولاني الذي يقابل ملكة الحس، والعقل المستفاد الذي يقابل ملكة الفهم، والعقل الفعال الذي يقابل العقل الخالص. هذا مع العلم بأن قوى النفس الأرسطية يختلط فيها الطبيعي بالسيكولوجي والميتافيزيقي، في حين أن القوى المعرفية عند كانط إبستيمولوجية وحسب. لكن التشابه بينهما لا يزال قائما على الرغم من ذلك.
نرى مما سبق كيف أن المشروع النقدي الرشدي يعتمد على المنظومة المنطقية الأرسطية، وأن المشروع النقدي الكانطي يعتمد على منظومة منطقية شبه أرسطية، تستوحي منطق أرسطو وتبني عليه لكنها لا تتجاوزه أبداً.
ثانياً – كانط والنقيضة الكوزمولوجية الأولى حول الحدوث والقدم:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
نقد كانط علوم الميتافيزيقا الثلاثة التي تبحث في النفس والعالم والإله. فعلم النفس العقلي يبحث في النفس من حيث جوهريتها وبساطتها وروحيتها وخلودها، وعلم الكوزمولوجيا العقلية يبحث في العالم من حيث أصله وكمه وتركيبه وعلته، وعلم اللاهوت العقلي يثبت وجود كائن ضروري بإطلاق، ببراهين أنطولوجية وكوزمولوجية. وما يهمنا تناوله هو نقده لعلم الكوزمولوجيا العقلية، لأنه هو ما تظهر فيه معالجة كانط لإشكالية قدم العالم وحدوثه، والتي هي محل المقارنة مع ابن رشد.
تسعى الكوزمولوجيا العقلية، في وصف كانط لها، إلى تكوين معرفة شاملة ونهائية بالعالم من حيث طبيعته وتكوينه وأصله؛ إذ تريد الوصول إلى التمام المطلق في معرفتنا بالعالم في كليته. وبذلك فهي تبحث في كَمِّه من حيث ما إذا كانت له حدود نهائية أم لا؛ ومن حيث الكيف فهي تبحث في تكوينه وما إذا كان مركباً من أجزاء بسيطة أم أن كل ما فيه معقد ولا يمكن أن ينحل إلى البسيط؛ ومن حيث السببية فهي تبحث فيما إذا كان كل ما فيه يسير حسب الضرورة والحتمية أم أن فيه علة تفعل بحرية؛ ومن حيث علته فهي تبحث فيما إذا كان مسيراً ذاته بذاته أم أنه معلول لكائن ضروري بإطلاق Absolutely Necessary Being ( ).
الكوزمولوجيا العقلية إذن تسعى نحو اللامشروط Unconditioned عن طريق التمام المطلق للشروط Absolute Completeness of Conditions. وحجتها في ذلك تراجعية، لأنها تنتقل من بعض الشروط المعطاة إلى الحكم على العالم في كليته وهو غير معطى للخبرة التجريبية باعتباره كذلك ، وتسعى نحو لامشروط غير معطى، لأن اللامشروط لا يخضع بطبيعته للحدس الحسي ولا للخبرة التجريبية( )؛ ناهيك عن أن كلية الشروط ذاتها غير معطاة، فالخبرة البشرية لا تحيط بالأسباب كلها. ولا يمكن أن نفهم كون كلية الشروط غير معطاة للخبرة وكون اللامشروط نفسه غير معطى إلا بالمقارنة بين كانط وابن رشد، ذلك لأن كانط بذلك يمارس نوعاً من نقد قياس الغائب على الشاهد الذي سبق لابن رشد استخدامه في نقد علم الكلام وخاصة نقد دليل الحدوث الكلامي في إثبات وجود الله، ذلك لأن كلية الشروط واللامشروط هما في حكم الغائب عند كانط، ولا يمكن الحكم على الغائب (اللامشروط) بالقياس على الشاهد (الشروط المعطاة للخبرة التجريبية).
ويتمثل نقد كانط لعلم الكوزمولوجيا العقلية في توضيح أن هذا العلم يقع في نقائض، والنقيضة تتمثل في قضيتين متعارضتين تنفي كل واحدة منهما ما تثبته الأخرى، وهما يستندان على استدلالين مختلفين لكل منهما وجاهته المنطقية وقوته الإقناعية. والنقيضة عند كانط هي ما لا نتمكن معها من ترجيح أحد الاستدلالين( ). والحل الذي يقدمه كانط هو في التخلي عنهما معاً، أي في توضيح تجاوزهما لقدرات العقل البشري، ذلك لأنهما نتاج سعي العقل الخالص في استعماله التأملي الميتافيزيقي نحو تجاوز نطاق الخبرة التجريبية والتفكير فيما لا يمكن أن يكون موضوعاً للتجربة. والنقائض أربع، تتكون كل واحدة منها من قضية ونقيض:
1.القضية: للعالم بداية في الزمان، كما أنه محدود في المكان (محدث).
نقيض القضية: ليس للعالم بداية وليس له حد في المكان، وهو لامتناه بالنظر إلى الزمان والمكان (قديم)( ).
2.القضية: كل جوهر مركب في العالم مكون من أجزاء بسيطة، ولا يوجد شئ إلا البسيط أو المركب من البسيط.
نقيض القضية: لا شئ مركب في العالم مكون من أجزاء بسيطة، ولا يوجد أي شئ بسيط في العالم( ).
3.القضية: ليست السببية وفق قوانين الطبيعة هي السببية الوحيدة التي ترجع إليها ظاهرات العالم. ولتفسير هذه الظاهرات يجب افتراض سببية أخرى من الحرية.
نقيض القضية: ليست هناك حرية؛ وكل شئ في العالم يحدث وفق قوانين الطبيعة وحسب( ).
4.القضية: ينتمي إلى العالم كائن ضروري بإطلاق، سواء كان جزءاً منه أو علة له.
نقيض القضية: لا يوجد كائن ضروري بإطلاق في العالم، ولا خارجه باعتباره علة له( ).
ومن الواضح أن النقيضة الأولى تمثل التعارض بين حدوث العالم وقدمه. وهذه هي الإشكالية التقليدية والمحورية التي كانت محل نزاع بين المتكلمين والفلاسفة في الإسلام؛ كفَّر الغزالي من أجلها الفلاسفة في “تهافت الفلاسفة” وعاد ابن رشد للدفاع، لا عن الفارابي وابن سينا، بل عن الفلسفة ذاتها، في “تهافت التهافت”. والنقيضة الثانية ظهرت في مشكلة نظرية الجوهر الفرد ودفاع الأشاعرة عنها ونقد الفارابي وابن سينا وابن رشد لها؛ والنقيضة الثالثة هي المشكلة التقليدية حول الحرية والحتمية، وتوازي الإشكاليات الإسلامية حول السببية وخرق العادة والإرادة الإلهية والإنسانية وموقعهما من قوانين الطبيعة؛ والنقيضة الرابعة هي مسألة وجود أو عدم وجود إله.
يمكن أن تكون النقائض الكوزمولوجية الأربع إذن محل دراسة مقارنة شاملة بين كانط من جهة وفلاسفة الإسلام من جهة أخرى. لكن علينا أن نركز في هذه الدراسة على الإشكالية الأساسية والمحورية وهي إشكالية القدم والحدوث، لأنها هي ما تلتف حولها بقية الإشكاليات. ما الذي يمكن أن نتوصل إليه عندما نقرأ نقد كانط للنقيضة الكوزمولوجية في الحدوث والقدم على خلفية مناقشة ابن رشد لنفس هذه الإشكالية في كتبه الثلاثة الرئيسية؟ إن كانط يوضح أن العقل البشري لا يستطيع الفصل في هذه الإشكالية واختيار أحد النقيضين لأنها تتجاوز قدراته المعرفية، أما ابن رشد فيدافع عن القدم ضد هجوم الغزالي عليه، ويثبت للعالم وضعاً وسيطاً بين القدم المطلق والحدوث المطلق، وينقد البرهنة الكلامية على وجود الله من دليل حدوث العالم ويذهب إلى أن البرهان الأفضل هو برهان القدم. هذه هي الملامح العامة للحل النهائي الكانطي والرشدي.
ولكن قبل المقارنة المفصلة بينهما يجب علينا التعرف على كيفية عرض كانط لإشكالية الحدوث والقدم، والتي لا يسميها بهذا الاسم بالطبع، بل يطلق عليها “التناهي واللاتناهي”.
تقول القضية إن العالم متناه في الزمان والمكان، أي محدث، ويقول نقيض القضية إن العالم لامتناه في الزمان والمكان، أي قديم. ويوضح كانط ما تتصف به القضية ونقيض القضية من معقولية، مما يثبت تساوي الأدلة التي في صالح الحدوث والأدلة التي في صالح القدم في الوقت نفسه. وهو يبدأ بالأدلة التي في صالح تناهي العالم. فإذا افترضنا أن العالم بدون بداية في الزمان فإن هذا يعني أن كل حادثة فيه قد سبقتها حوادث أخرى لانهاية لها، ولا يمكن أن تأتي حادثة من سلسلة لامتناهية من الحوادث. فكي نثبت ظهور حادثة يجب علينا افتراض بداية أولى للزمان. أما فيما يخص المكان فإذا افترضناه كلاً لامتناهياً فلا معنى لوجود الأمكنة الجزئية، لأن المكان الجزئي ما هو إلا تركيب لبعض خصائص المكان الواحد الكلي، أي اللامتناهي. واللامتناهي لا يمكن أن يُخصَّص أو يُجزأ، وبالتالي فلا يمكن انقسام المكان اللامتناهي، لأن المنقسم هو المتناهي وحده. وبما أن هناك أمكنة جزئية، وبما أنه من الممكن أن ينقسم المكان، فيجب علينا القول بتناهي المكان( ).
أما نقيض القضية فهو يثبت لاتناهي العالم من حيث الزمان والمكان ببراهين لا تقل قوة ولا إقناعاً عن براهين التناهي. فإذا افترضنا أن للعالم بداية، وبما أن كل بداية تفترض زماناً خالياً سبقها، فمعنى هذا أننا نفترض زماناً سابقاً على وجود العالم كان خالياً منه. لكن لا يمكن ظهور شئ من زمان خالٍ، لأن الزمان الخالي لا يمتلك شرطاً يميز وجود أو عدم وجود العالم، أي ليس به مرجح للوجود على العدم بالتعبير الإسلامي. وإذا افترضنا فيما يخص المكان أن العالم متناه ومحدود من حيث الكم الممتد، فمعنى هذا أن العالم يقع في مكان خالٍ، وهذا مستحيل إذ ينطوي على القول بأن للعالم صلة بمكان خالٍ، أي باللاشئ. فلا يبقى إلا القول بأن العالم لامتناه من حيث الامتداد( ).
وينقد كانط نقيضة القدم والحدوث عن طريق نظريته في المعرفة بذهابه إلى أن المكان والزمان ليسا موضوعين للمعرفة حتى يمكن أن نفكر في تناهيهما أو لاتناهيهما، ذلك لأنهما مجرد شكلان لحدسنا، أي تمثلان قبليان في العقل البشري يجعلان المعرفة ممكنة. وأخذ الشرط الذاتي للمعرفة على أنه موضوع للمعرفة غير مشروع لدى كانط. هذا بالإضافة إلى أن كل ما نعرفه من العالم هو الظاهر، والمكان والزمان هما الشرطان الذاتيان اللذان تُعطى لنا عن طريقهما الموضوعات في عالم الظاهر، وبالتالي فالعلاقات المكانية والزمانية بين الأشياء هي عالم الظاهر الذي يبدو لنا حسب الشروط الذاتية لمعرفتنا، أما الأشياء في ذاتها فلا يمكننا معرفتها وليس لدينا من سبيل للوصول إليها انطلاقاً من شروطنا المعرفية الذاتية( )؛ فالبحث في طبيعة المكان والزمان هو بحث غير مشروع لما هو مجرد شرط ذاتي للمعرفة وتوسيعه بالنظر إليه على أنه يوجد قائماً بذاته، أي أخذهما على أنهما شيئان في ذاتيهما والنظر إليهما على أنهما الطريقة التي تترتب بها الأشياء في ذاتها لا مجرد الطريقة التي تعطى لنا بها موضوعات الخبرة بعالم الظاهر.
وهكذا سد كانط الطريق على أية إمكانية لحل إشكالية القدم والحدوث بذهابه إلى أنها تتجاوز قدرة العقل البشري، وهي بحد ذاتها نتيجة للتوسيع غير المشروع لما هو مجرد شرط ذاتي للمعرفة البشرية إلى اعتباره قائماً بذاته. يتمثل جوهر النقد الكانطي للميتافيزيقا إذن في تقييد المعرفة بالمجال الإبستيمولوجي وحده وبيان عدم مشروعية الانتقال مما هو إبستيمولوجي إلى ما هو أنطولوجي، أو أخذ الشروط الذاتية للمعرفة البشرية على أنها شروط موضوعية للوجود الأنطولوجي للأشياء في ذاتها. والحقيقة أن هذا النقد هو صورة جديدة من صور نقد قياس الغائب على الشاهد والذي سبق لابن رشد استخدامه. فالغائب هو الأنطولوجي، أو عالم الأشياء في ذاتها، والذي لا يمكننا أن نقيسه على الشاهد، أو الإبستيمولوجي الخاص بعالم الظاهر، أي عالم الخبرة التجريبية. وسوف نتناول بالتفصيل علاقة النقد الكانطي بنقد ابن رشد لقياس الغائب على الشاهد. أما عن قول كانط بعدم مشروعية الفصل والاختيار بين القدم والحدوث على أساس أنها إشكالية تتعدى قدرات المعرفة البشرية فلنا عليه رد ومن داخل نظرية كانط في المعرفة، وسوف يأتي تباعاً؛ لأن كانط الذي رفض لاتناهي العالم أنطولوجياً في “الجدل الترانسندنتالي” كان قد سبق وأن أثبته إبستيمولوجياً في “الإستطيقا الترانسندنتالية” و”التحليلات الترانسندنتالية”.
ولا ينسى كانط أن يناقش حلاً شبيهاً بحله لإشكالية القدم والحدوث، وهو الحل الذي يرفض الإشكالية ويقول بأن العالم لا هو بالمتناهي ولا هو باللامتناهي في الوقت النفسه. فكانط ينبه القارئ على أنه لا يقول بهذا الرأي، لأن هذا الرأي يصدر حكماً بالفعل على العالم ويؤكد بصدده على طبيعة معينة يثبتها له، في حين أن العالم عند كانط غير معطى باعتباره كلاً في حدس حسي أو في خبرة تجريبية، بل معطى باعتباره كُلاً في التسلسل الترانسندنتالي للأسباب والموجه بفكرة الكل الترانسندنتالية( )، وهذا التسلسل ومعه الفكرة الترانسندنتالية الموجهة له غير مشروع في نظر كانط حسب نظريته في المعرفة.
كان هذا هو كل حديث كانط عن إشكالية قدم العالم وحدوثه. ونفاجأ بأن إشكالية وجود أو عدم وجود كائن ضروري للعالم، وهي مشكلة الألوهية وعلاقتها بالعالم، تشغل النقيضة الرابعة. لقد فصل كانط بين إشكالية العالم وإشكالية الألوهية ووضع كل إشكالية في نقيضة مستقلة عن الأخرى، تتوسطهما نقيضتا العالم بين البساطة والتركيب، وبين الحرية والحتمية. والحقيقة أن هذا الفصل يعد عيباً خطيراً في نظرية كانط في النقائض، وفي كل نقده للميتافيزيقا التقليدية؛ ذلك لأنه لا يمكن مناقشة إشكالية قدم العالم وحدوثه بمعزل عن قدم الإله وإشكالية علاقة الألوهية بالعالم. وعندما نأتي على نظرية ابن رشد في العالم وموقفه من إشكالية القدم والحدوث سنلاحظ مدى التلاحم بين الألوهية والعالم، مما يدل على استحالة الفصل بينهما وخطأ هذا الفصل ابتداء، لكن هذا هو ما فعله كانط. هذا بالإضافة إلى أن النقيضة الرابعة لا تجد أي مشكلة في القول بكائن ضروري داخل العالم أو خارجه؛ إنها تقول : “ينتمي إلى العالم كائن ضروري بإطلاق، سواء كان جزءاً منه أو علة له”، أي علة خارجة عنه. لم يلاحظ كانط أن هذه القضية في حد ذاتها تعبر عن نقيضة، تتمثل في التناقض في القول بكائن ضروري داخل العالم وفي القول بكائن ضروري خارج العالم؛ فهذا التناقض كان بالفعل محل نزاع ميتافيزيقي واسع في تاريخ الفلسفة، وهو المميز للنزاع بين المذاهب التي تقول بالإله المفارق للعالم ومذاهب وحدة الوجود. وسوف نلاحظ في مقارنتنا مع ابن رشد كيف أن الأخير كان على وعي بهذه الإشكالية وقدم لها حلاً مبتكراً، ذلك لأنها تدخل فيما يعرف في الفلسفة الإسلامية بإشكالية صدور الكثرة عن الواحد وإشكالية علم الله للجزئيات.
هذا علاوة على أن عرض كانط للنقائض الكوزمولوجية بالطريقة السابق توضيحها يوحي أن القضية في كل نقيضة تنتمي إلى مذهب واحد، ونقيض القضية في كل نقيضة يمثل المذهب الآخر المضاد، بمعنى أن القضايا الأربع تشكل مذهباً ونقائضها الأربع تشكل مذهباً آخر مضاداً؛ بحيث يكون المذهب القائل بحدوث العالم هو نفسه الذي يقول بتكونه من أجزاء بسيطة وبوجود سببية حرة فيه وبكائن ضروري بإطلاق (وبذلك يكون قريباً للغاية من مذهب الأشاعرة الذين يقولون بالجزء الذي لا يتجزأ، وقد كان في عصر كانط مذهباً شبيهاً به وهو مذهب المونادات عند لايبنتز)، ويكون المذهب المقابل هو الذي يقول بقدم العالم ولاتناهيه من حيث الزمان والمكان وبعدم تكونه من أجزاء بسيطة وبعدم وجود سببية حرة فيه وبعدم وجود كائن ضروري بإطلاق. والواضح أن هذين المذهبين لا يستوعبان كل المذاهب الميتافيزيقة التي عرفها الفكر الإنساني، كما لا يستوعبان كل الخلافات المذهبية التي نشبت بين المذاهب الميتافيزيقية المختلفة. إن التعارض الذي يقيمه كانط في النقائض الكوزمولوجية هو تعارض واحد فقط بين مذهبين وحسب، وهما مذهب الخلق من العدم والمذهب الدهري. المذهب الأول يمثله أفلاطون وأوغسطين وعلماء الكلام المسلمون وكل فلاسفة العصور الوسطى المسيحية، والمذهب الدهري يمثله في عصر كانط بعض الماديين الفرنسيين من أصحاب الموسوعة وبعض أتباع السبينوزية ( ). والحقيقة أن كانط اعتقد خطأً أنه ليس هناك خيار ثالث بين النقائض الكوزمولوجية الأربع، ذلك لأن مذهب ابن رشد نفسه هو الذي قدم خياراً ثالثاً وسيطاً بين القدم المطلق والحدوث المطلق، وبذلك لا يشمله نقد كانط للكوزمولوجيا العقلية ولا يقع في الإحراجات المنطقية التي يقيمها بين القدم والحدوث.
ثالثاً – توسط ابن رشد بين القدم المطلق والحدوث المطلق:
- سياقات معالجة ابن رشد للمسألة:
أ. السياق المنطقي:
كان ابن رشد يعلم أن السؤال عن العالم أهو قديم أم محدث هو سؤال جدلي، وذلك كما يتضح في شرحه لكتاب “الجدل” لأرسطو. فالسؤال عن قدم العالم أو حدوثه هو مطلوب جدلي حسب تعبيره. ويقول عنه: “وأما المطلوب الجدلي فهو ما لم يكن معلوماً صدقه بنفسه بحسب المشهور، بل يلحقه شك ما في المشهور..والسبب في الشك الواقع فيها [=في مقدمات القياس الجدلي] إما تضاد الشهادة، وإما عدم الشهادة فيها، وإما تضاد الأقيسة.. وربما كان سبب ذلك عسر وجود القياس عليها.. مثل قولنا: هل العالم محدث أم لا؟… وأما ما تتضاد فيه الأقيسة، فمثل قولنا: هل العالم قديم أو محدث؟”( ). الواضح من النص أن ابن رشد يفصل بين السؤال عن حدوث العالم والسؤال عن الاختيار بين قدمه وحدوثه. والسبب في فصله هذا يرجع إلى أنه قدم نقداً لبراهين المتكلمين على حدوث العالم، وهي مستقلة تماماً عن أدلته هو في القول بقدم وحدوث العالم في الوقت نفسه ( ).
والملاحظ أن ابن رشد يعالج الأسئلة عن قدم العالم وحدوثه على أنها مطالب جدلية، لأن الأقيسة تتضاد فيها. لقد كان كانط على حق إذن عندما عالج إشكالية القدم والحدوث تحت باب “الجدل الترانسندنتالي”( )، وعندما وضع الإشكالية في صورة نقيضة Antinomy، إذ اتضح تضاد الأقيسة الذي يقصده ابن رشد من برهان الحدوث وبرهان القدم اللذان وضعهما كانط في مقابل بعضهما البعض في تقسيمه الشهير للصفحة الواحدة إلى عمودين. لكن يجب علينا الانتباه إلى أن النص السابق هو من شرح ابن رشد لكتاب أرسطو في الجدل، فهو يكتفي فيه بتوضيح أن السؤال عن القدم والحدوث مطلب جدلي لكنه لم يقدم حله لهذا السؤال في شرحه للجدل نفسه، بل في كتبه الأساسية الثلاثة: “فصل المقال” و”الكشف عن مناهج الأدلة” و”تهافت التهافت”. والسبب في ذلك واضح، وهو أن أرسطو لم يكن حاسماً في حله لمسألة القدم والحدوث، مثلما كان في مسألة العقل الفعال واتصاله بالبدن؛ وربما يكون أرسطو قد سكت عن هذه المسألة لكونها مطلباً جدلياً كما يقول، لكن ابن رشد هو الذي تجاوز الصعوبة الجدلية للمسألة بمحاولة حلها. والحقيقة أن المسألة الجدلية لا تحل إلا برفع النقيضين معاً، وهذا ما فعله ابن رشد عندما قام برفع القدم المطلق والحدوث المطلق وقال بأن العالم قديم ومحدث في الوقت نفسه. وهذا أيضاً ما فعله كانط؛ لقد رفع النقيضين معاً، لكن لا بالتوسط بينهما بل برفض الفصل في المسألة أصلاً واعتبارها مما يفوق قدرات العقل البشري، مكرراً بذلك نفس الحل الذي قال به من قبل فلاسفة العصور الوسطى وعلى رأسهم ألبرت الكبير والقديس توماس الأكويني( ). ولذلك فالحل الذي قدمه ابن رشد للمسألة هو حله هو، ولا يعد أبداً نقلاً عن أرسطو، فنظرية التوسط بين القدم والحدوث لم يقل بها أرسطو ولم تظهر في أي من مؤلفاته، بل هي نظرية رشدية أصيلة.
ب. سياق نقد علم الكلام:
رفض ابن رشد نظرية حدوث العالم الكلامية. ومن أسباب رفضه لها أنها:
- ليست قائمة على أدلة برهانية يقينية.
- لا تستطيع البرهنة الصادقة على وجود الله، لأن البرهنة على أن العالم حادث تنطوي على إشكالية صدور الحادث عن القديم، وإشكالية التناقض بين الإرادة القديمة والفعل الحادث.
- تعصف بالثبات والضرورة التي لقوانين الطبيعة وتكرس لمبدأ الاتفاق وتنظر إلى السببية على أنها مجرد عادة، وبالتالي لا تستطيع أن تنظر إلى حكمة الله في خلق العالم وفق ما فيه من ضرورة.
والحقيقة أن نظرية ابن رشد في أن الطريقة البرهانية اليقينية في إثبات وجود الله هي دليل القدم لا دليل الحدوث يعني أنه يدافع عن النظرة العلمية للكون والتي تنظر إليه على أن قوانينه ضرورية وتحكمه السببية الشاملة. وليس هناك أي تعارض لدى ابن رشد في القول بحتمية وأبدية وأزلية قانون الطبيعة والقول بإله صانع للعالم، لأن قانون الطبيعة عنده هو إرادة الله وحكمته في خلقه، وهو “سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا”. “وينبغي أن تعلم أن من جحد كون الأسباب مؤثرة بإذن الله من مسبباتها، أنه قد أبطل الحكمة وأبطل العلم” على الله وعلى الإنسان معاً “والقول بنفي الأسباب في الشاهد ليس له من سبيل إلى إثبات سبب فاعل في الغائب”( )
ذهب ابن رشد إلى أن دليل المتكلمين على وجود الله من حدوث العالم ليس يقينياً ولا برهانياً. فهذا الدليل ينبني على ثلاث مقدمات تقول: “الجواهر لا تنفك عن الأعراض أي لا تخلو منها، والثانية أن الأعراض حادثة، والثالثة أن ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث” ( ). وبالتالي فالعالم حادث لأنه لا ينفك عن الحوادث، وبما أن العالم حادث فهو يفتقر إلى محدث له وهو الله.
وينقد ابن رشد هذا الدليل بذهابه إلى أن القول بأن الجواهر لا تنفك عن الأعراض لا يعني بالضرورة أنها هي ذاتها أعراض، وذلك نظراً لإمكان حدوث أعراض لانهاية لها على الجواهر؛ ويقول في ذلك: “وأما المفهوم الأول.. فليس يلزم عنه حدوث المحل، أعني: الذي لا يخلو من جنس الحوادث. لأنه يمكن أن يتصور المحل الواحد، أعني الجسم، تتعاقب عليه أعراض غير متناهية.. كأنك قلت: حركات لانهاية لها”( ) كما أن الجواهر تنحل، لدى الأشاعرة خاصة، إلى الجزء الذي لا يتجزأ، وانحلالها هذا لا يعني أنها أعراض، لأن التحليل وصل إلى الجزء، أي إلى شئ متقدم في وجوده على الجسم المركب، وهذا لا يعني الحدوث.
أما المقدمة الثانية القائلة بأن الأعراض حادثة فهي تنطوي على قياس الغائب على الشاهد، أي الانتقال مما هو حاضر أمام الحس من الحادثات إلى الحكم على ما لا يحضر، أي الغائب. ومعنى هذا النقد أن المتكلمين على خطأ في انتقالهم من حدوث الأعراض إلى حدوث العالم كله، لأن الأعراض هي الشاهد الذي لا يصح أن نقيس عليه العالم كله وهو الغائب، ذلك لأن النقلة من حكم الأعراض الجزئية إلى الحكم على العالم في كليته غير صحيح، لأن الأعراض الجزئية ليست من طبيعة العالم الكلي: “فتؤول أدلتهم على حدوث جميع الأعراض إلى قياس الشاهد على الغائب، وهو دليل خطابي إلا من حيث النقلة معروفة بنفسها، وذلك عند التيقن باستواء طبيعة الشاهد والغائب”( ).
أما المقدمة الثالثة القائلة إن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث فهي جدلية لأنها ترتكب مغالطة الاشتراك في الاسم، فالحادث الذي لا تخلو الجواهر منه ليس هو حدوث العالم، فالحدوث مستخدم بمعنيين مختلفين في كل شق من المقدمة. كما أن عبارة “ما لا يخلو من الحوادث” يمكن أن تعني ما لا يخلو من جنس الحوادث كله وما لا يخلو من واحد منها. لكن ما لا يخلو من جنس الحوادث يمكن ألا يكون حادثاً بل قديماً تمر عليه الحوادث إلى ما لا نهاية( ). وهكذا يثبت ابن رشد أن دليل الحدوث جدلي وخطابي ولا يرقى للبرهان. - التمييز بين القدم المطلق والحدوث المطلق:
القديم بإطلاق عند ابن رشد هو ما ليس له علة ولا يوجد من شئ، أما المحدث بإطلاق فهو ما له علة ووجد من شئ. القديم المطلق هو الله سبحانه، والحادث المطلق هو الأشياء الجزئية أو الأجسام. أما العالم فهو يتوسط القدم المطلق والحدوث المطلق؛ إنه أزلي الحدوث. سبق أن لاحظنا في عرضنا للنقيضة الكوزمولوجية الأولى عند كانط أنه يقيم تعارضاً بين القدم المطلق والحدوث المطلق ويقول بأن العالم إما متناهياً في الزمان والمكان وإما لامتناهياً في الزمان والمكان ولا شئ غير ذلك، أي أنه لم يتعرض أبداً للخيار الوسيط. أما ابن رشد فنجد لديه عرضاً أكثر شمولاً للإشكالية وحلاً وسيطاً مبتكراً لها. ولأن ابن رشد قد ركز عرضه للإشكالية وحله لها في صفحة ونصف من كتابه “فصل المقال” فسوف نوردها بنصها كاملة لنعرف كيف عالج ابن رشد مسألة القدم والحدوث وكيف حلها في بضعة أسطر. وما يبرر لنا إيراد النص التالي كاملاً ما يظهر فيه من توسط ابن رشد بين القدم والحدوث للعالم، وهو ما ليس له نظير عند كانط. إن هذه الأسطر القليلة التي حل بها المسألة تقف دليلاً على عبقرية هذا الرجل، وفي الوقت نفسه على أن كانط لم يقرأ “فصل المقال” ولا أي من مؤلفات ابن رشد، وقد خسر الكثير من جراء ذلك.
يقول ابن رشد( ): “وأما مسألة قدم العالم [أو] حدوثه [فإن الاختلاف] [فيها] عندي بين المتكلمين من الأشعرية وبين الحكماء المتقدمين يكاد أن يكون راجعاً للاختلاف في التسمية، وبخاصة عند بعض القدماء. وذلك أنهم اتفقوا على أن هاهنا ثلاثة أصناف من الموجودات: طرفان وواسطة بين الطرفين. فاتفقوا في [تسمية] الطرفين واختلفوا في الواسطة. فأما الطرف الواحد فهو: موجود وجد من شئ غيره وعن شئ: أعني عن سبب فاعل ومن مادة، والزمان متقدم عليه: أعني على وجوده. وهذه هي حال الأجسام التي يدرك تكونها بالحس، مثل تكون الماء والهواء والأرض والحيوان والنبات وغير ذلك. فهذا الصنف من الموجودات اتفق الجميع من القدماء والأشعريين على تسميتها محدثة. وأما الطرف المقابل لهذا فهو موجود لم يكن من شئ ولا عن شئ، ولا تقدمه زمان. وهذا أيضاً اتفق الجميع من الفرقتين على تسميته قديماً. وهذا الموجود مدرك بالبرهان، وهو الله تبارك وتعالى الذي هو فاعل الكل، وموجده، والحافظ له، سبحانه وتعالى قدره.وأما الصنف من الموجود الذي بين هذين الطرفين فهو موجود لم يكن من شئ ولا تقدمه زمان، ولكنه موجود عن شئ: أعني عن فاعل. وهذا هو العالم بأسره. والكل منهم متفق على وجود هذه الصفات الثلاث للعالم. فإن المتكلمين يسلمون أن الزمان غير متقدم عليه، أو يلزمهم ذلك. إذ الزمان عندهم شئ مقارن للحركات والأجسام، وهم أيضاً متفقون مع القدماء على أن الزمان المستقبل غير متناه، وكذلك الوجود المستقبل، وإنما يختلفون في الزمان الماضي والوجود الماضي. فالمتكلمون يرون أنه متناه، وهذا هو مذهب أفلاطون وشيعته. وأرسطو وفرقته يرون أنه غير متناه كالحال في المستقبل. فهذا الموجود الآخر الأمر فيه بَيـِّن أنه قد أخذ شبهاً من الوجود الكائن الحقيقي ومن الوجود القديم. فمن غلَّب عليه ما فيه من شبه القديم على ما فيه من شبه المحدث سماه قديماً. ومن غلَّب عليه ما فيه من شبه المحدث سماه محدثاً. وهو في الحقيقة ليس محدثاً حقيقياً ولا قديماً حقيقياً. فإن المحدث الحقيقي فاسد ضرورة. والقديم الحقيقي ليس له علة”( ).
أي أن العالم ليس قديماً على الحقيقة وليس محدثاً على الحقيقة، بل هو قديم ومحدث في الوقت نفسه، قديم بمعنى صدوره الدائم والأبدي عن الله تعالى، ومحدث بمعنى افتقاره إلى علة موجدة له تقع خارجه. يتضح من النص السابق كيف استطاع ابن رشد التمييز بدقة بين القدم المطلق والحدوث المطلق والتوسط بينهما بالنسبة للعالم. والحقيقة أن هذا التمييز ليس موجوداً في فلسفة أرسطو، بل هو فكرة رشدية أصيلة. صحيح أنها تعد تطويراً لبعض الأفكار الأرسطية، إلا أن ابن رشد هو أول من قال بها، وهي من الأفكار التي نجح ابن رشد في التوفيق بها بين الفلسفة والدين. وهذا التوسط بين القدم والحدوث لا نجده في عرض كانط للنقائض الكوزمولوجية.
كما نلاحظ أن ابن رشد يعالج القدم والحدوث بطريقة أكثر شمولاً، ذلك لأنه يُدخل في المناقشة قدم الله، ويقيم علاقة ثلاثية بين القديم المطلق وهو الله والحادث المطلق وهو الأجسام الجزئية والوسيط بينهما وهو العالم؛ في حين أن كانط قد فصل بين إشكالية العالم وإشكالية وجود الله؛ فإشكالية القدم والحدوث تشغل النقيضة الأولى، وإشكالية وجود أو عدم وجود الكائن مطلق الضرورة تشغل النقيضة الرابعة، أي أنه تناول قضية القدم والحدوث بمعزل عن قضية الكائن مطلق الضرورة. أما الأجسام الجزئية فهي تناظر عند كانط النقيضة الثانية الخاصة ببساطة أو تركيب الجواهر المفردة في العالم، وقد عزل مناقشته لها عن إشكاليتي العالم والإله أيضاً.
وما قاله ابن رشد في التمييز بين القدم المطلق والحدوث المطلق باختصار في “فصل المقال”، يعود ليُفصِّله بمزيد من الشرح في “تهافت التهافت”، ويضيف عليه التمييز بين قدم الله وقدم العالم. يقول ابن رشد: “وأما إن كان العالم قديماً بذاته وموجوداً لا من حيث هو متحرك، لأن كل حركة مؤلفة من أجزاء حادثة، فليس له فاعل أصلاً، وأما إن كان قديماً بمعنى أنه في حدوث دائم وأنه ليس لحدوثه أول ولا منتهى، فإن الذي أفاد الحدوث الدائم أحق باسم الإحداث من الذي أفاد الحدوث المنقطع. وإنما سمت الحكماء العالم قديماً تحفظاً من المحدث الذي هو من شئ وبعد العدم”( ). يتضح من هذا النص أن ابن رشد يميز بين القديم بإطلاق والمحدث بإطلاق. القديم بإطلاق هو ما ليس له علة، وإذا كان العالم قديماً بهذا المعنى فليس له علة؛ وهذا هو قدم العالم الذي ينفي وجود الإله، وهو ما يظهر في النقيضة الكوزمولوجية الرابعة لكانط، ويقابل المذهب الدهري. فالواضح أن كانط لم يفهم القدم والحدوث بالمعنى الذي يشير إليه ابن رشد في النص السابق. فكانط يربط بين قدم العالم من جانب وكونه بدون إله صانع من جانب آخر، ولم يستوعب أبداً كيف يمكن للعالم أن يكون قديماً وله صانع في الوقت نفسه. لا يقول ابن رشد بقدم العالم بمعنى كونه بدون علة موجدة، بل يقول بقدم العالم بمعنى الحدوث الدائم، ويقول بأن ما هو دائم الحدوث أولى بأن يسمى حادثاً مما حدوثه منقطع، أي ما وجد بعد العدم. ليس العالم قديماً بذاته عند ابن رشد، بل هو قديم بغيره، أي بالإله، وهو ليس محدثاً بإطلاق، بل محدث بذاته.
- التمييز بين نوعين من الأزلية:
تبنى ابن رشد تمييز أرسطو بين نوعين من الأزلية أو القدم: النوع الأول هو الأزلية الثابتة اللازمانية، أي التي لا يمر عليها الزمان ولا يلحقها التبدل أو التحول، وهي عند أرسطو أزلية المحرك الأول الذي لا يتحرك؛ والنوع الثاني هو الأزلية الزمانية المتحركة أو الاستمرارية الأبدية في الحركة، وهي الحركة الدائرية اللامتناهية للسماء والأفلاك. وهذا التمييز هو الذي يستطيع إفهامنا لكيفية قول ابن رشد بقدم الله وقدم العالم في الوقت نفسه؛ فليس هناك أي تناقض عنده في القول بقديمين، لأن كل قدم منهما بمعنى مختلف عن قدم الآخر. الله والعالم عند ابن رشد أزليان أبديان لكن لا بمعنى واحد. أزلية الله عند ابن رشد هي الأزلية الثابتة اللازمانية غير المتحركة، فالله لا يخضع للزمان ولا للتبدل والتحول الذي للحركة؛ أما أزلية العالم فهي الأزلية المتحركة حركة لانهاية لها. وعندما ذهب ابن رشد إلى أن العالم يأخذ شبهاً من الوجود القديم وشبهاً من الوجود الحادث فقد كان يعني أنه يأخذ معنى الدوام الأزلي الأبدي الذي يميز القديم، وفي الوقت نفسه معنى الحركة الذي ينطوي على الحدوث. فالعالم عند ابن رشد أزلي الحركة، أي أزلي الحدوث؛ إنه في حالة حدوث دائم وأبدي وأزلي. وهكذا نرى أن ابن رشد نجح في تجاوز إشكالية القدم والحدوث بأن تجاوزهما معاً عن طريق التوسط بينهما والجمع في شأن العالم بين معنى للقدم ومعنى آخر للحدوث. لقد تجاوز إحراج الاختيار بين القدم المطلق والحدوث المطلق الذي ظهر في النقيضة الكوزمولوجية الأولى عند كانط. تنص هذه النقيضة على أن العالم إما قديم أو محدث، ولا ثالث لهما، وقد كان من السهل على كانط رفض الفصل في الإشكالية بحجة أنها تتجاوز قدرات العقل البشري. أما ابن رشد فقد نجح في التوصل إلى الخيار الثالث الوسيط بين القدم المحض والحدوث المحض، ذلك الخيار الذي لم يطرحه كانط أصلاً وغاب عن أفق تفكيره.
- التمييز بين الحدوث الذاتي والحدوث من العدم:
♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
ميز ابن رشد أيضاً بين معنيين للحدوث: الحدوث الذاتي وهو افتقار الشئ إلى علة موجدة له، والحدوث من العدم وهو وجود شئ بعد أن لم يكن( ). وعندما يسمي ابن رشد العالم حادثاً فهو يعني به الحدوث الذاتي، أي أن العالم يفتقر إلى علة موجدة له تسبقه منطقياً لا زمانياً، لكنه ليس حادثاً من العدم. الحادث من العدم هو الذي يسبقه العدم، وذلك مثل الأجسام المادية في العالم، أما العالم كله فهو حادث بذاته قديم بغيره، أي أنه يصدر بالضرورة عن فعل الله، أو هو بالأحرى فعل الله نفسه( )، ولا يمكن أن يتوقف الله عن الفعل أو يبدأ في الفعل بعد أن كان متوقفاً عنه.
وعندما ناقش كانط مسألة العالم في النقيضة الأولى ومسألة الكائن الضروري بإطلاق في النقيضة الرابعة (وهو واجب الوجود بتعبير ابن سينا) لم يتناول هذه التقسيمات الفرعية بين القدم والحدوث. فكما أوضح لنا ابن رشد، فللقدم معنيان وللحدوث معنيان، ومن الممكن التوسط بينهما. أما كانط فالعالم عنده إما قديم أو محدث، هكذا ببساطة؛ وهو إما أن يكون قديماً بدون إله أو محدثاً بإله، هكذا ببساطة أيضاً. لكن معالجة ابن رشد لإشكاليات القدم والحدوث لم تكن بالبساطة التي ظهرت في معالجة كانط، بل كانت أكثر تنوعاً وتعقيداً وثراءً. إن كانط يكشف عن تعارض واحد فقط وهو بين المذهب الدهري ومذهب الخلق من العدم. وهو يعتقد أن هذا التعارض هو المشكلة الأساسية للعقل الخالص، لكنها ليست كذلك. المشكلة الأساسية كانت هي المشكلة محل النزاع الفارابي وابن سينا من جهة والمتكلمين من جهة أخرى، وبين الغزالي والفلاسفة، وبين ابن رشد والغزالي. إن السبب في بساطة عرض كانط للنقائض الكوزمولوجية والتي تصل إلى حد السذاجة يرجع إلى أنه لم يطلع على النزاعات والصراعات الكلامية والفلسفية في الفكر الإسلامي؛ ولو كان قد اطلع عليها لزاد كتابه ثراء، ولرأى كيف أن بين القدم والحدوث خيار ثالث وسيط وضعه ابن رشد.
- العالم قديم بالجنس حادث بالأجزاء:
♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
ينظر ابن رشد إلى العالم على أنه قديم أو أزلي بالجنس حادث بالأجزاء. فالعالم عنده أزلي بالجنس أي في كليته وشموله وإذا ما اتخذ على أنه الكل الشامل، لأنه بذلك فعل للإله، وفعل القديم قديم مثله. لكنه في الوقت نفسه حادث بالأجزاء، أي الأشياء المادية من أجسام وعناصر، لأنها هي التي تمر بالتغير والتحول والتبدل، أو الكون والفساد. يقول ابن رشد في ذلك: “الجهة التي منها أدخل القدماء موجوداً قديماً ليس بمتغير أصلاً ليست هي من جهة وجود الحادثات عنه بما هي حادثة، بل بما هي قديمة بالجنس؛ والأحق عندهم أن يكون هذا المرور إلى غير نهاية لازماً عن وجود فاعل قديم، لأن الحادث إنما يلزم أن يكون بالذات عن سبب حادث”( )، ويقول أيضاً: “..وجه صدور الحادث عن القديم الأول لا بما هو حادث بل بما هو أزلي بالجنس حادث بالأجزاء، وذلك أن كل فاعل قديم عندهم إن صدر عنه حادث بالذات فليس هو القديم الأول عندهم..”( ). إن وجود أجسام جزئية حادثة عند ابن رشد لا يعني أن العالم كله حادث، لأن هذا يعد قياساً للغائب، وهو العالم كله، على الشاهد، وهو الأجسام الجزئية. فالعالم كله هو في حكم الغائب عند ابن رشد لأنه ليس خاضعاً للحس باعتباره كلاً، ولأننا نطلب حكماً يخص أوله وآخره وهما أيضاً في حكم الغائب. وابن رشد بذلك يخالف المتكلمين من معتزلة وأشاعرة والذين ذهبوا إلى أن العالم كله حادث بما أنه يحوي أجساماً حادثة، لأن هذا الدليل، بالإضافة إلى أنه قياس للغائب على الشاهد، فهو أيضاً قياس الكل على أجزائه أو الامتداد بحكم الجزء إلى الحكم على الكل، وهو قياس غير صحيح وفقاً لقواعد البرهان. ونلاحظ من ذلك أن ابن رشد لم يكن بحاجة إلى الخروج عن المنطق الأرسطي واختراع منطق آخر لنقد الميتافيزيقا الدوجماطيقية لعلم الكلام مثلما اضطر كانط لاختراع منطق جديد بالتوازي مع المنطق الأرسطي وأسماه “المنطق الترانسندنتالي”. تثبت لنا أعمال ابن رشد أن المنطق الأرسطي كان لا يزال صالحاً عنده كأداة لنقد الميتافيزيقا، أي أورجانوناً Organon ، دون الحاجة إلى اختراع منطق جديد.
ونلاحظ كذلك أن قول ابن رشد “والأحق عندهم أن يكون هذا المرور إلى غير نهاية لازماً عن وجود فاعل قديم” يدل على أن توالي وتسلسل حدوث الحادثات إلى ما لا نهاية هو ما يليق بحق القديم، لأن القديم هو ما لا يتوقف عن الفعل وهو أيضاً ما لا يتوقف فعله. فحدوث العالم عند ابن رشد هو حدوث لانهائي، أزلي وأبدي.
ويتضح لنا من النص السابق من “فصل المقال” أن العالم قديم ومحدث في الوقت نفسه عند ابن رشد، قديم بالجنس من حيث كونه كلاً، حادث بالأجزاء؛ وتعد هذه النظرية هي الأفضلية التي يتفوق فيها ابن رشد على كانط في التعامل مع إشكالية القدم والحدوث، بها تكون فلسفة ابن رشد متجاوزة للنقائض الكوزمولوجية الكانطية ومتجنبة الوقوع في الإحراجات المنطقية التي أوضحها كانط. ذلك لأن كانط اعتقد أن العالم إما أن يكون قديماً كلاً وأجزاءً أو حادثاً كلاً وأجزاءً، والحقيقة أن النقائض الكوزمولوجية الكانطية هي بين هذين النوعين المحدودين من القدم والحدوث. لكننا رأينا كيف توسط ابن رشد بين هاتين النقيضتين اللتين قطع كانط بعدم إمكان العقل البشري الفصل فيهما. ويبدو أن عقل كانط وحده هو الذي لم يتمكن من الفصل فيهما، لا العقل البشري كما ادعى هو.قدم لنا كانط الخياران المتناقضان في كل نقيضة على أنهما كل ما هو متاح للعقل البشري، لكن اتضح لنا من النص الرشدي كيف يمكن التوسط وكيف أن الخيار الثالث الوسيط بين القدم والحدوث يمكن تبريره عقلياً وبالبرهان، أي دون الخروج عن قواعد المنطق.
رابعاً – وحدة الوجود هي ما يقتضيه مذهب ابن رشد، وهي المختفية من النقد الكانطي للميتافيزيقا:
الحقيقة أن كانط قد نقد نوعاً واحداً فقط من الميتافيزيقا على الرغم من أن كتابه “نقد العقل الخالص” يوحي بأنه ينقد كل الميتافيزيقا بمختلف أنواعها. وبأنه ينقد كل تفكير ميتافيزيقي. إنه بالأحرى ينقد صنفاً واحداً من التفكير الميتافيزيقي والذي ينتج الميتافيزيقا القائلة بنظرية معينة في النفس والعالم والإله، وهي ميتافيزيقا أفلاطون وفلاسفة العصور الوسطى المسيحيين وديكارت ومدرسته. بالإضافة إلى اقترابها الشديد من فلسفة المتكلمين من معتزلة وأشاعرة. هذه النظرية تنظر إلى النفس على أنها جوهر مستقل عن البدن وتقول بروحيتها وخلودها بعد فناء البدن، وتقول بأن العالم إما قديم أو محدث ولا ثالث لهما، وتقدم أخيراً أدلة وبراهين على وجود الإله، لكنها أدلة وبراهين تثبت وجود الإله المفارق المنفصل عن العالم. ومعنى هذا أن النقد الكانطي للميتافيزيقا لا يستوعب المذهب الأرسطي – الرشدي القائل بوحدة الكيان الإنساني من حيث كونه يتكون من مادة وصورة، أي بدن ونفس لا ينفصلان ولا يحيا هذا الكيان الإنساني بدون اتحادهما، ولا يستوعب كذلك المذهب الرشدي الأصيل القائل بالتوسط بين القدم والحدوث للعالم وبأن العالم قديم ومحدث في الوقت نفسه، ولا يستوعب أيضاً النتيجة المنطقية لفلسفة ابن رشد والتي يقتضيها مذهبه وهي وحدة الوجود، أي النظر إلى الإله على أنه ليس مفارقاً أو منفصلاً عن العالم بل القول بالهوية التامة بينه وبين فعله، وبين هذا الفعل ونتاج هذا الفعل وهو ما يعني بوضوح وحدة الوجود. سوف نوضح فيما يلي كيف أن مذهب وحدة الوجود عند ابن رشد هو الذي ينجح في تجاوز النقد الكانطي للميتافيزيقا، وأن هذا النقد لا يستوعبه ولا يمكن أن يشمله، ليس فقط لأن مصطلح “وحدة الوجود” Pantheism مختفٍ تماماً من “نقد العقل الخالص”، بل كذلك لأن النقد الكانطي هو لنوع واحد فقط من الميتافيزيقا ولا يشمل ميتافيزيقا وحدة الوجود.
يتفق كل من أرسطو والفارابي وابن سينا وابن رشد في القول بأن العالم قديم. واعترض الغزالي على الفارابي وابن سينا لأن القول بقدم العالم هو قول بقديمين، وهذا في نظره قريب من الشرك( )، لأن القديم يجب أن يكون واحداً فقط وهو الله وحده. لكن الشرك الحقيقي هو في القول بشركاء للإله الواحد في الفعل والخلق والإيجاد، أي القول بإلهين أو أكثر. أما القول بقدم العالم عند ابن رشد فليس بشرك، لأن قدم العالم عنده لا يعني أن العالم شريك للإله، ولا يعني كذلك نقصاً في وحدانية الإله؛ فالإله يبقى واحداًَ مع قدم العالم، ويبقى العالم من صنعه وإبداعه مع كونه قديماً، وذلك بناءً على أن العالم هو فعل الإله الدائم والمستمر من الأزل إلى الأبد، ولا يمكن تأخر المفعول وهو العالم عن فعل الفاعل وهو الإله، وكذلك لا يمكن تأخر الإله عن فعله أو تراخيه في فعل هذا الفعل. ولذلك نقد ابن رشد نظرية تراخي الإرادة عند الغزالي والأشاعرة.
لكن لا يمكن التوفيق بين إله قديم وعالم قديم وتجنب الوقوع في الإشكاليات الناتجة عن القول بقديمين إلا بناءً على مذهب وحدة الوجود؛ أي بالذهاب إلى أن القديم واحد، إله وفعل هذا الإله. فالإله وفعله متلازمان، هو قديم وفعله قديم في الوقت نفسه. فالتوحيد الحقيقي هو التوحيد بين الإله وفعله، أما القول بوجود عالم منفصل ومختلف عن الإله حتى ولو كان محدثاً فهو نقص في وحدانية الله، لأن اللإله الواحد الحق هو الذي لا يقف أي شئ في مقابله ويواجهه في تناقض، كأن يكون الإله روحي والعالم مادي، وكأن يكون الإله مفارقاً للعالم وكأنه في مكان فوق العالم أو خارجه. والحقيقة أن مذهب وحدة الوجود هو النتيجة المنطقية التي تقتضيها فلسفة ابن رشد. وسوف نحاول فيما يلي توضيح ذلك من نصوص ابن رشد.
تتمثل الاعتبارات التي تجعلنا نقطع بأن مذهب ابن رشد يؤدي منطقياً إلى القول بوحدة الوجود فيما يلي:
- أنه يتبنى النظرية الأرسطية القائلة إن الإله عقل وعاقل ومعقول وإنه لا يعقل إلا ذاته.
- أنه يقول بالتلازم التام بين الإله وفعله، وفعل الإله هو العالم.
- أنه يقول بأن الإله لا يفعل بآلة، وبأن المخلوقات تصدر عنه بدون وسائط.
- أنه يقول بإمكان وجود موجود ليس داخل العالم وليس خارجه، مع رفع التناقض الظاهري في ذلك؛ وهو الإله عنده.
ولتوضيح كيف أن هذه الأفكار الأربع تشير بقوة إلى وحدة الوجود نشرحها بالتفصيل فيما يلي. - الإله عقل وعاقل ومعقول:
♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
تبنى ابن رشد النظرية الأرسطية القائلة إن الإله عقل وعاقل ومعقول، وأنه تبعاً لذلك لا يعقل إلا ذاته. لكن أدت هذه الفكرة إلى إشكالية وهي أن الإله على أساسها لن يعقل الجزئيات. ولتجنب هذه الصعوبة ذهب ابن سينا إلى أن الإله يعقل الجزئيات على نحو كلي. وأخذ الغزالي على الفلاسفة الذين يقولون بذلك أن قولهم هذا يؤدي إلى القول بأن صانع العالم لا يعلم صنعه. وقد حل ابن رشد هذه الإشكالية بذهابه إلى أن الصفات ليست زائدة على الذات، بمعنى أنها هي هي عين الذات؛ ولأن العلم من صفات الذات، فالعلم ليس صفة منفصلة عن الذات الإلهية. ومعنى هذا أن الإله باعتباره عاقلاً لا يتعقل بقوة أو ملكة متمايزة عن ذاته، بل يتعقل بذاته نفسها. وبذلك وحد ابن رشد بين العقل وهو الإله والتعقل وهو العلم الإلهي. وكذلك وحد بينهما وبين المعقول. ذلك لأن العالم عنده هو المعقول، وعندما نقول إن الإله عقل وعاقل ومعقول، وعندما نقوم بالتوحيد وإقامة الهوية بين الثلاثة، فكأننا وحدنا بين الإله وفعله ونتاج هذا الفعل الذي هو العالم ومعرفته بهذا العالم؛ وهذه هي وحدة الوجود بعينها. وقد تجاوز ابن رشد إشكالية القول بأن الله لا يعلم الجزئيات بذهابه إلى أن هذه الجزئيات هي صنعه، ومجموعها هو العالم كله، ولأنه يعقل ذاته وفعله، ولأن فعله غير منفصل عنه، فمعنى هذا أن الإله عندما يتعقل ذاته فهو يتعقل العالم في الوقت نفسه، لأن العالم نتاج فعله.
إن حل إشكالية القول بأن الإله لا يعلم إلا ذاته هو مذهب وحدة الوجود؛ فالإله بالفعل لا يعلم إلا ذاته، لأنه ليس هناك في الوجود إلا الإله وذاته وأفعاله. وقد سبق لابن رشد أن وحد بين الذات والصفات، والأفعال أيضاً. إن ذات الإله في هوية تامة مع صفاته وأفعاله عند ابن رشد. صحيح أن الإله لا يعلم إلا ذاته حسب ما يقول أرسطو والفلاسفة المشائين، إلا أن هذه الفكرة لا تؤدي إلى القول بأنه لا يعلم غيره، فليس هناك غير. فحسب مذاهب وحدة الوجود ليس هناك إله مفارق ومنفصل عن العالم ومختلف عنه جوهرياً، لأن الإله ليس له ضد وليس أمامه مقابل؛ وهذا ما تشترك فيه بالرغم من الاختلافات الجزئية بينها.
- التلازم التام بين الإله وفعله:
♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
أما عن التلازم التام بين الإله وفعله فيقول ابن رشد: “فيلزم أن تكون أفعال الفاعل الذي لا مبدأ لوجوده ليس لها مبدأ كالحال في وجوده”( ). أي أن أفعال الفاعل، التي هي العالم، لامتناهية وقديمة، لأنها أفعاله هو. وهذا هو التوحيد بين الإله وفعله، أي الإله والعالم، أي وحدة الوجود. لقد تبنى ابن رشد مذهب وحدة الوجود على نحو أكثر وضوحاً وصراحة من أرسطو ومدرسته، لأن الإله عند أرسطو هو مجرد محرك أول لا يتحرك، أي أنه ليس له أي دور فاعل في حركة العالم، ذلك لأن العالم عند أرسطو متحرك بذاته حركة شوق إلى المحرك الأول الثابت، وهي حركة غائية فقط، والإله عنده علة غائية للعالم وليس علة فاعلة، لكنه علة فاعلة عند ابن رشد، وهذا هو ما يفصله ويميزه عن أرسطو. والعالم عند ابن رشد ليس صادراً عن الإله على التوالي وفي تسلسل هابط مثلما هو الحال في الأفلاطونية المحدثة وأتباعها الإسلاميين مثل الفارابي وابن سينا، بل العالم صادر عنه مباشرة وهو يفعل مباشرة في العالم دون وسائط. يقول في ذلك: “وإذا كان ذلك كذلك، لزم ضرورة أن لا يكون واحد من أفعاله الأولى شرطاً في وجود الثاني، لأن كل واحد منهما هو غير فاعل بالذات، وكون بعضها قبل بعض هو بالعرض”( ). إن فعل الإله عند ابن رشد واحد، ولا يصدر عنه مفعول يفعل بذاته؛ ونتاج هذا الفعل الواحد هو عالم واحد. ونتاجه هذا ملازم له دائماً، وهذه هي وحدة الوجود.
- الإله يفعل بلا آلة:
أما أن الإله لا يفعل بآلة، أي لا يفعل في العالم بوسيط أو أداة عند ابن رشد، فمعناه أن فعله في العالم مباشر. ذهب ابن رشد إلى أننا لا يمكننا أن نقيس فعل الإله على أفعال البشر، لأن هذا القياس هو قياس للغائب على الشاهد، ولأنه ينطوي على تشبيه الإله بالإنسان. فالإنسان يولد بإنسان يسبقه، وهو يفعل باستخدام وسيط بينه وبين موضوع فعله، لأن هناك انفصالاً بينه وبين موضوعه. لكن الإله ليس في حاجة إلى وسيط كما أنه ليس هناك انفصال بينه وبين موضوع فعله. ومعنى هذا أن الإله هو العلة الفاعلة المباشرة في العالم، ولا يمكن أن يكون علة فاعلة مباشرة إذا كان هناك انفصال بينه وبين العالم، فالإله محايث للعالم، وإرادته هي قوانين الطبيعة ذاتها( ).
القول بموجود ليس داخل العالم وليس خارجه:
♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
أما عن دفاعه عن القول بموجود ليس داخل العالم وليس خارجه فيقول في ذلك: “..كما أدى البرهان إلى أشياء هي متوسطة بين أشياء يظن بها، في بادئ الرأي، أنها متقابلة، وليست متقابلة، مثل قولنا موجود لا داخل العالم ولا خارجه”( ). ويقصد ابن رشد نظرية أرسطو في موقع المحرك الأول، إذ يذهب إلى أنه إذا كان داخل العالم فكيف يكون محركاً له والحركة تفترض أن تكون هناك مسافة بين المحرك والمتحرك، وإذا كان خارج العالم فكيف يحركه أيضاً وليس بينهما احتكاك. والحل الذي قدمه أرسطو هو القول بأنه داخل وخارج العالم في الوقت نفسه. إنه داخل العالم لكن لا على سبيل احتواء العالم له ولا على سبيل أنه جزء منه، وهو خارج العالم لكن لا على سبيل أنه منفصل عنه. والعالم يتحرك إليه شوقاً، أي حركة غائية وحسب. والواضح أن هذه النظرية تؤدي إلى وحدة الوجود أيضاً.
وأعتقد أن ابن رشد قد تبنى تلك النظرية لكن بكثير من التعديلات ولم يقبلها كما هي موجودة في مذهب أرسطو. فعندما كان ابن رشد يناقش مسألتي الجسمية والجهة في “الكشف عن مناهج الأدلة”، نفى الجسمية تماماً وقام بتأويل الآيات التي تفيد بظاهرها معنى الجسمية، وقد كان واضحاً جداً في ذلك؛ أما عندما أتى على مسألة الجهة فلم يكن بمثل ذلك الوضوح. ذلك لأنه بدأ بالقول بأن “ظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة.. لأن الشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء، وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين، وأن من السماء نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي (ص)”( ). وبعد ذلك مباشرة قام بتوضيح موقف المعتزلة في نفي الجهة وذهب إلى أن ما دعاهم إلى ذلك أنهم اعتقدوا أن كل ما في الجهة فهو في المكان وهو جسم: “والشبهة الي قادت نفاة الجهة إلى نفيها، هي أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان، وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية”( ). وينشغل ابن رشد بعد ذلك بإثبات أن القول بالجهة لا يعني إثبات المكان ولا الجسمية. صحيح أنه أثبت للإله الجهة حسب ظاهر الشرع، إلا أنه لم يوضح كيف يكون الإله في جهة دون أن يكون في مكان ودون أن يكون جسماً. وإذا نظرنا في “تهافت التهافت” وجدناه يرفض النظرية القائلة بأن الإله هو نفس العالم، بمعنى أنه ليس هو النفس لجسد هو العالم( )، لأن هذا في نظره يعد تشبيها للإله بالإنسان وينطوي على القول بأن الإله إنسان أزلي( ).
لقد ترك ابن رشد مسألة الجهة دون حسم. لكنني أعتقد أن الحل هو ربطها بما يقتضيه مذهبه من وحدة الوجود. ذلك لأن الإله عند ابن رشد ليس بجسم ولا في مكان لكنه في جهة. وكونه ليس في مكان يعني أنه ليس في مكان واحد جزئي بحيث يكون هذا المكان أكبر منه ويشمله، لكنه في الوقت نفسه في جهة، فكيف نحل هذه الإشكالية؟ أعتقد أن الحل يكمن في القول بأن الإله ليس في مكان واحد بل هو في كل مكان، مما يعني وحدة الوجود. وهذا أيضاً ما تدل عليه الآية القائلة “أينما تولوا فثم وجه الله”، والوجه والجهة متلازمان، وكل مكان به وجه الله، أي جهة لله. وكذلك يقول الكتاب العزيز: “الله نور السموات والأرض”؛ أي أنه نور في السموات والأرض، وليس نوراً خارجهما ينيرهما عن بعد، إنه النور الداخل والمحايث للعالم.
الإله إذن ليس داخل العالم بمعنى أنه ليس جزءاً منه، لكنه داخل العالم باعتبار أنه العلة الفاعلة لكل ما يحدث في العالم حسب نظرية ابن رشد في الخلق المستمر، وإرادته تشمل كل العالم والتي هي قوانين الطبيعة؛ وهو ليس خارج العالم بمعنى أنه ليس منفصلاً عنه ولا يشكل العالم جوهراً مادياً مستقلاً ومنفصلاً عن الإله ذي الجوهر الروحي، فليس هناك جوهران بل جوهر واحد كما يقول سبينوزا، ولكنه خارج العالم بمعنى أنه مفارق للمادة ولا يخضع للتغير والتبدل والتحول الذي يحدث للعالم. أعتقد أن هذا هو المعنى الذي كان يقصده ابن رشد عندما تبنى نظرية أرسطو في الموجود الذي لا هو داخل العالم ولا هو خارجه؛ وهو ما تؤيده نصوص رشدية كثيرة للغاية، خاصة في “تهافت التهافت”( ).
ومن الواضح أن نقد كانط للميتافيزيقا، وبالأخص للكوزمولوجيا العقلية، لا يستوعب هذه الأفكار، وهذا ما يتضح إذا قارناها بالنقائض الأربع التي سبق وأن عرضناها. هذا علاوة على أن كانط قد فصل بين نقده للمذهب الميتافيزيقي في العالم ونقده للبراهين الميتافيزيقية على وجود الإله. فنقده لمذهبي القدم والحدوث يوجد في فصل يسمى “نقائض العقل الخالص” The Antinomy of Pure Reason و ينقد فيه الكوزمولوجيا العقلية، أما نقده لبراهين وجود الإله فهو في الفصل التالي له بعنوان “مثال العقل الخالص” The Ideal of Pure Reason. لكننا رأينا كيف أن ابن رشد لا يفصل بين العالم والإله، سواء في عرض موقفه الخاص في “فصل المقال” و”الكشف عن مناهج الأدلة”، أو في تفنيده للغزالي ودفاعه عن الفلسفة في “تهافت التهافت”. إن كانط فصل بين المذهب الميتافيزيقي في العالم والبراهين الميتافيزيقية على وجود الإله لأنه يفصل من الأصل بينهما، أما ابن رشد فلم يفصل، أولاً لأن الفحص في الإله وفي العالم لا يمكن أن يتم بمعزل الواحد منهما عن الآخر، وثانياً لأن المذهب الرشدي هو مذهب وحدة الوجود، فكان من الطبيعي أن يتناول ابن رشد الإله والعالم معاً وفي تلازم عبر كل مؤلفاته
ا